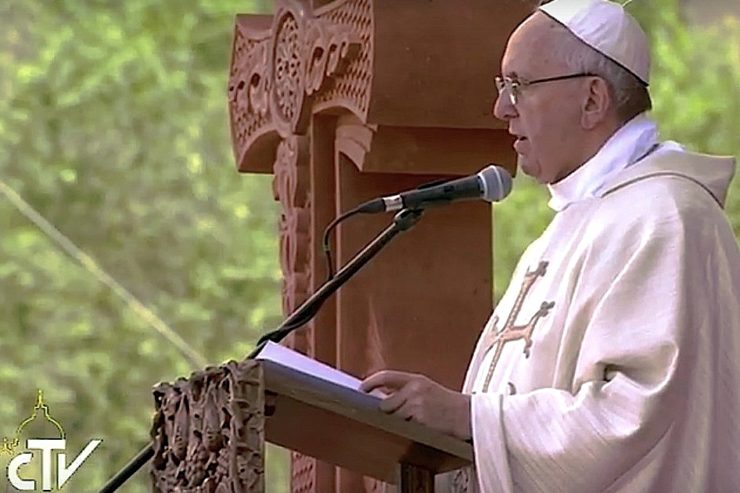“يُشَيِّدونَ مُدَمَّراتِ قَديمِ الأَيَّام وُيجَدِّدونَ المُدُنَ المُخَرَّبة” (أش 61، 4). يمكننا القول، في الأماكن هذه، أيها الإخوة الأعزاء، بأن كلمات النبي أشعيا التي سمعناها قد تحقّقت. فبعد الدمار الرهيب الذي أحدثه الزلزال، إننا هنا اليوم، لنقدّم الشكر لله على كلّ ما قد أُعيد بناؤه.
يمكننا أن نسأل أنفسنا أيضًا: ماذا يدعونا الرب أن نبني اليوم في حياتنا، وقبل كل شيء: على أي شيء يدعونا أن نبني حياتنا؟ أودّ أن أقترح عليكم، وأنتم تبحثون عن جواب لهذا السؤال، ثلاث قواعد ثابتة، يمكننا أن نبني عليها حياتنا المسيحية، أو أن نعيد بناءها، دون تعب.
أول أساس هو الذاكرة. هناك نعمة يجب أن نطلبها وهي معرفة كيفية استعادة الذاكرة؛ ذاكرة كلّ ما صنع الربّ فينا ولنا: نسترجع ذاكرة أنه، كما يقول إنجيل اليوم، لم ينسانا، بل “ذَكَرَنا” (لو 1، 72): فقد اختارنا، وأحبّنا، ودعانا، وصفحَ عنا؛ وقد جرت أمورٌ عظيمةٌ في قصّة حبّنا الشخصي له، والتي يجب استرجاع ذكراها في الذهن وفي القلب. ولكن، هناك أيضًا ذاكرة أخرى يجب الحفاظ عليها: ذاكرة الشعب. للشعوب في الواقع ذاكرة، على غرار الأفراد. وذاكرة شعبكم هي قديمة جدًّا وثمينة. وفي أصواتكم، ترنّ أصوات حكماء الماضي القديسين؛ ويعود في كلامكم صدى الذي ابتكر أبجديتكم بغية التبشير بكلمة الله؛ وفي تراتيلكم تندمج آهات وأفراح تاريخكم. إن فكّرتم بهذا كلّه يمكنكم بالتأكيد أن تروا حضور الله: فهو لم يترككم لوحدكم. يمكننا القول، في وسط الشدائد الهائلة أيضًا، أنه قد افتَقَدَ شَعبَه (را. لو 1، 68): لقد ذكر إخلاصكم للإنجيل، وباكورة ثمار إيمانكم، وجميع الذين شهدوا، على حساب دمائهم، على أن محبّة الله هي أفضل من الحياة (را. مز 63، 4). إنه لجميل أن تستطيعوا التذكّر بامتنان، أن الإيمان المسيحي قد أصبح نفسَ شعبِكم وقلبَ ذاكرتِه.
إن الإيمان أيضًا هو رجاء مستقبلكم، ونور درب الحياة، وهو الأساس الثاني الذي أودّ أن أكلمكم عنه. هناك دومًا خطر باستطاعته أن يلاشي نور الإيمان: وهو أن نقع تحت تجربة اعتبار الإيمان كمجرّد أمرٍ من الماضي، أمر مهم ولكنه ينتمي إلى زمنٍ آخر، كما ولو كان كتاب منمنمات يجب الحفاظ عليه في المتحف. لكن الإيمان، إن أُغلِقَ في أرشيف التاريخ، يفقد قوّته المحوّلة، وجماله الحيويّ، وانفتاحه الإيجابيّ نحو الجميع. فالإيمان، على العكس، يولَدُ وينهضُ من اللقاء المُحيي بيسوع، ومن خبرةِ رحمته التي تنير كلّ أوضاع الحياة. من الفيد لنا أن نحيي كلّ يوم هذا اللقاء بالرب. ومن الفيد لنا أن نقرأ كلمة الله وأن ننفتح على محبّته في الصلاة الصامتة. ومن الفيد لنا أن ندع لقاءَنا بحنان الرب يُشعِل الفرحَ في القلب: فرحٌ أكبر من الحزن، فرحٌ يقاوم الألم، ويتحوّل إلى سلام. إن كلّ هذا يجدّد الحياة، ويجعلها حرّة ومنفتحة على المفاجآت، جاهزة ومستعدة للرب وللآخرين. قد يحدث أيضًا أن يقوم يسوع بدعوتنا إلى اتباعه عن كثب، وإلى وهب حياتنا له وللإخوة: عندما يدعو، لا تخافوا، بالأخصّ أنتم الشباب، قولوا له “نعم”! فهو يعرفنا، ويحبّنا حقًّا، ويرغب بتحرير قلبنا من ثقل الخوف والكبرياء. إن أفسحنا له المجال، نصبح قادرين على أن نشعّ بالمحبّة. ويمكنكم بهذه الطريقة أن تكملوا تاريخًا عظيمًا من التبشير، تحتاج إليه الكنيسة والعالم في هذا الزمن العصيب، والذي هو أيضًا زمن الرحمة.
الأساس الثالث، بعد الذاكرة والإيمان، هو الحب الرحيم: فعلى هذه الصخرة، صخرة المحبة التي نلناها من الله وأعطيناها للقريب، تُبنى حياة تلميذ يسوع. وبعيشنا المحبة، يتجدّد وجه الكنيسة ويصبح جذّابًا. إن المحبة الملموسة هي بطاقة عمل المسيحي: إن قدّمنا أنفسنا بأسلوب آخر، إنما هو تضليل وحتى غير مجدي، لأنه من محبّتنا يعرف الجميع بأننا تلاميذه: إن أحببنا بعضنا بعضًا (را. يو 13، 35). إننا مدعوّون قبل كلّ شيء إلى بناء وإعادة بناء سبل الشركة، دون أن نكلّ أبدًا، وإلى بناء جسور الاتّحاد، وإلى تخطّي الحواجز التي تفصل. ليعطِ المؤمنون المثل على الدوام، بالتعاون فيما بينهم بالاحترام المتبادل والحوار، مدركين أن “التنافس الوحيد الممكن بين تلاميذ الرب، هو أن نختبر مَن يقدر أن يمنح حب أعظم!” (يوحنا بولس الثاني، عظة، 27 سبتمبر/أيلول 2001: تعاليم XXIV، 2 [2001]، 478).
ذكّرنا النبي أشعيا، في القراءة الأولى، أن روح الرب يرافق دومًا مَن يحمل البشارة إلى المساكين، يَجبُرَ جراح منكسري القلوب ويعزّي المحزونين (را. 61، 1- 2). الله يسكن في قلوب الذين يحبّون؛ الله يقيم فيمن يحبّ، ويعتني بالضعفاء والفقراء، بشجاعة وتعاطف. هناك حاجات كبيرة: حاجة إلى المسيحيين الذين لا يستسلمون للتعب ولا تحبطهم الشدائد، إنما هم مستعدون ومنفتحون، جاهزون للخدمة؛ هناك حاجة إلى رجال ذوي إرادة صالحة، يساعدون، بالفعل وليس فقط بالكلام، الإخوة والأخوات الذين يمرون بصعوبات؛ هناك حاجة إلى مجتمع أكثر عدالة، يمكن لأي شخص فيه أن يحيا حياة كريمة، وأن يحصل قبل كل شيء على عمل مأجور بشكل عادل.
ولكن بإمكاننا أن نتساءل: كيف يمكن أن نصبح رحماء، مع كل ما نرى من العيوب والمآسي في داخل كلّ منا ومن حولنا؟ أودّ أن أستمد إلهامي من مثلٍ ملموس، من مبشّرٍ عظيم للرحمة الإلهية، قد أردت لفت انتباه الجميع إليه، إذ عددته بين معلمي الكنيسة الجامعة: القديس غريغوريوس الناريكي، كلمة أرمينيا وصوتها. من الصعب العثور على شخص مثله، في فهم البؤس السحيق الذي يمكن أن يعشش في قلب الإنسان. ولكنه قد أقام على الدوام حوارًا بين البؤس البشري والرحمة الإلهية، رافعًا تضرعات ملؤها الدموع والثقة إلى الرب، “معطي الهبات، والصلاح بطبيعته، […]، وصوت العزاء، والخبر المريح، وزخم الفرح، […]، والحنان الذي لا يضاهى، والرحمة الفائضة، […]، والقبلة الخلاصية” (كتاب المراثي، 3، 1)، موقنًا “أن ظلام الغضب لايخيمّ أبدًا على نور رحمته” (نفس المرجع، 16، 1). غريغوريوس الناريكي هو معلم حياة، لأنه يعلمنا أن أهم شيء هو أن نعترف بحاجتنا إلى الرحمة وثم، ألا ننغلق على أنفسنا إزاء البؤس والجراح التي نراها، إنما أن ننفتح للرب بصدق وبكل ثقة، “الله قريب، إنه حنان وصلاح” (نفس المرجع، 17، 2)، “مملوء محبة للبشر، […] نار تلتهم اعشاب الخطيئة” (نفس المرجع، 16، 2).
أودّ أخيرًا أن أستدعي، بكلمات القديس، الرحمةَ الإلهية وعطيةَ ألا نتعب أبدًا من أن نحبّ: أيها الروح القدس، “الحامي القدير، والوسيط، وصانع السلام، إليك نوجه تضرّعاتنا […] أعطنا نعمة تشجيعنا على المحبة وعلى الأعمال الصالحة […] يا روح الوداعة والتعاطف والرحمة ومحبّة للبشر، […] يا من لست إلّا الرحمة، […] إرحمنا، أيها الرب إلهنا، بحسب كثرة رأفتك” (نشيد العنصرة).
***********
© جميع الحقوق محفوظة – حاضرة الفاتيكان 2016
© Copyright – Libreria Editrice Vaticana