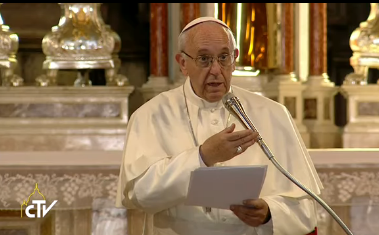إن ليتورجيّا اليوم تقدّم لنا ثلاث كلمات أساسيّة لحياة الرسول: إعلان الإيمان، الاضطهادات، الصلاة.
إعلان الإيمان هو إعلان إيمان بطرس في الإنجيل، حين ينتقل سؤال الربّ من العام إلى الخاص. فقد سأل يسوع في الواقع أوّلا: “مَنِ ابنُ الإِنسانِ في قَولِ النَّاس؟” (متى 16، 13). ويَظهَر من هذا “الاستقصاء” أن الشعب بأكثريّته يعتبر يسوع نبيًّا. وحينها يطرح المعلّم على التلاميذ السؤال الحاسم حقّا: “ومَن أَنا في قَولِكم أَنتُم؟” (آية 15). وهنا وحده بطرس يجيب: “أَنتَ المسيحُ ابنُ اللهِ الحَيّ” (آية 16). هذا هو إعلان الإيمان: الاعتراف بأنّ يسوع هو المسيح المُنتَظَر، الله الحيّ، وربّ حياتنا الشخصيّة.
إن يسوع يطرح هذا السؤال الأساسيّ اليوم علينا، علينا جميعًا، ولا سيّما نحن الرعاة. إنّه السؤال الحاسم، الذي لا يمكن الإجابة عليه بشكل عام، لأن الحياة هي على المحك: والسؤال الحياتيّ يتطلّب إجابة حياتيّة. لأنّ معرفة بنود الإيمان لا تفيد إلّا القليل إن لم نعترف بيسوع ربًّا على حياتنا. وهو ينظر إلينا اليوم في أعيننا ويسألنا: “من أنا في قولك أنت؟”. وكأنّه يقول: “أما زلت أنا ربّ حياتك، ووجهة قلبك، وسبب رجائك، وثقتك التي لا تتزعزع؟”. لنجدّد نحن أيضًا اليوم، مع القدّيس بطرس، خيار حياتنا كتلاميذ ورسل؛ ولننتقل مجدّدًا من أوّل سؤال إلى ثاني سؤال طرحه يسوع، كي نكون “له” لا بالكلام فقط، إنّما بالأعمال والحياة.
لنسأل أنفسنا إن كنّا مسيحيّ الصالونات، الذين يتحدّثون حول مسار الأمور في الكنيسة وفي العالم، أم رسل في مسيرة، يعلنون إيمانهم بيسوع عبر حياتهم لأنّه في قلبهم. فمَن يُعلن إيمانه بيسوع يعرف أنّه ليس عليه أن يُبدي رأيه وحسب، بل أن يهبَ حياته؛ يعرف أنّه لا يمكنه أن يؤمِن بفتور، إنّما هو مدعوّ إلى أن “يحترق” محبةًّ؛ يعرف أنّه في الحياة، لا يستطيع أن “يطفو” أو أن يتّكئ في الرخاء، بل عليه أن يخاطر ويسير في العمق، مُجَدِّدًا كلّ يوم بذلَ ذاته. مَن يُعلن إيمانه بيسوع يتمثّل ببطرس وبولس: يتبعه حتى النهاية؛ ليس فقط إلى حدّ ما، إنّما حتى النهاية، ويتبعه على دربه هو، لا على دروبنا نحن. دربه هي درب الحياة الجديدة، درب الفرح والقيامة، الدرب التي تمرّ ايضًا بالصليب والاضطهادات.
ها هي الكلمة الثانية، الاضطهادات. لم يهرق بطرس وبولس وحدهما الدمّ من أجل المسيح، فالجماعة بأسرها قد اضطهدت في بادئ الأمر، كما ذكّرنا به سفر أعمال الرسل (را. 12، 1). اليوم أيضًا في أنحاء مختلفة من العالم، وفي جوّ من الصمت أحيانا – بشكل غير نادر صمت متواطئ -، الكثير من المسيحيّين هم مهمّشين، ويُفترى عليهم، ويتعرّضون للتمييز، وهم عرضة للعنف حتى القاتل منه، وغالبَا ما يُحرمون من واجب الذين باستطاعتهم فرض حقوقهم المقدسة.
أودّ أن أشير قبل كلّ شيء إلى حين أكّد بولس الرسول أنّه “يٌقَدَّم قربانًا للربّ” –كما كتب- (2 طم 4، 6). الحياة عنده هي المسيح (را. فل 1، 21)، والمسيح المصلوب (را 1 قور 2، 1)، الذي بذل حياته من أجله (را. غل 2، 20). وهكذا تبع بولس المعلّم، كتلميذٍ أمين، واهبًا هو أيضًا حياته. دون الصليب ما من مسيح، لا بل حتى ما من مسيحيّ دون الصليب. في الواقع، “ما يعود للفضيلة المسيحيّة، هو ليس فقط عمل الصالحات، إنّما أيضًا معرفة احتمال الشرّ” (أغسطينوس، خط. 46، 13)، مثل يسوع. واحتمال الشرّ ليس فقط الصبر والتقدّم بمضض؛ الاحتمال هو التمثّل بيسوع: هو حمل الثقل، وحمله على الكتفين من أجله ومن أجل الآخرين. هو قبول الصليب، والمضيّ قدما بثقة لأنّنا لسنا لوحدنا: الربّ المصلوب والقائم من الموت هو معنا. ويمكننا هكذا أن نقول مع بولس أنّه “يُضَيَّقُ علَينا مِن كُلِّ جِهَةٍ ولا نُحَطَّم، نَقَعُ في المآزِقِ ولا نَعجِزُ عنِ الخُروج مِنها، نُطارَدُ ولا نُدرَك، نُصرَعُ ولا نَهلِك” (2 قور 4، 8- 9).
الاحتمال هو أن نعرف كيف نفوز مع يسوع ووفقًا لطريقته، لا وفقًا لأسلوب العالم. لذا يعتبر بولس أنه فائز –لقد سمعناه- ويستعدّ لنيل الإكليل (را. 2 طم 4، 8) فيكتب: “جاهَدتُ جِهادًا حَسَنًا وأَتمَمْتُ شَوطي وحافَظتُ على الإِيمان” (آية 7). السلوك الأوحد لجهاده الحسن كان العيش من أجل: لم يعش من أجل نفسه، إنما من أجل يسوع ومن أجل الآخرين. عاش وهو “يجري”، أي دون أن يزهد بنفسه، لا بل باذلًا نفسه. ويقول إنه حافظ على أمر واحد: لا العافية، إنّما الإيمان، أي إعلان إيمانه بيسوع. وقد عاش محبّةً به، المحنَ، والإهانات، والآلام، التي لا يجب أبدًا البحث عنها، إنّما قبولها. وهكذا، عبر سرّ الألم الذي نقدّمه محبّةً، عبر هذا السرّ الذي يجسّده اليوم أيضًا الكثير من إخوتنا المضطّهدين والفقراء والمرضى، تشعّ قوّة صليب المسيح المخلّصة.
الكلمة الثالثة هي الصلاة. حياة الرسول، التي تنبع من إعلان الإيمان وتصبّ في البذل، تتدفّق كلّ يوم في الصلاة. الصلاة هي الماء الذي لا غنى عنه والذي يغذّي الرجاء وينمّي الثقة. الصلاة تجعلنا نشعر بأنّنا محبوبون وتسمح لنا بأن نحبّ. تجعلنا نسير قدمًا في الأوقات المعتمة، لأنها تضيء نور الله. ففي الكنيسة، الصلاة هي التي تسندنا جميعا وتجعلنا نتخطّى المحن. ونراه أيضًا في القراءة الأولى: “فكانَ بُطرُسُ مَحفوظًا في السِّجْن، ولكِنَّ الصَّلاةَ كانت تَرتَفِعُ مِنَ الكَنيسةِ إِلى اللهِ بِلا انقِطاعٍ مِن أَجلِه” (رسل 12، 5). فالكنيسة التي تصلّي يحفظها الربّ وتسير برفقته. أن نصلّي يعني أن نسلّمه المسيرة، كي يعتني بها. الصلاة هي القوّة التي توحّد وتدعم، وهي العلاج للعزلة والاكتفاء الذاتي اللذان يقودان إلى الموت الروحيّ. لأنّ الروح المحيي لا يعصف إن لم نصلِّ، ودون الصلاة لا تنفتح السجون الداخلية التي تأسرنا.
لينلْ لنا الرسل القدّيسون قلبًا مثل قلبهم، متعب بالصلاة ومسالم: متعب لأنه يسأل ويقرع ويشفع، محمّلًا بالكثير من الأشخاص والأوضاع التي يجب أن يعهد بها للربّ؛ لكنه في الوقت عينه مسالم، لأن الروح يحمل العزاء والقوّة عندما نصلّي. وكم هو ملحّ أن يكون هناك معلّمي صلاة في الكنيسة، لكن أن يكونوا أوّلًا رجال ونساء صلاة، يعيشون الصلاة!
الربّ يتدخّل حين نصلّي، الربّ الذي هو أمين للمحبّة التي أظهرناها له، ويبقى بقربنا وقت المحن. لقد رافق هو مسيرة الرسل وسوف يرافقكم أنتم أيضًا، أيها الإخوة الكرادلة الأعزّاء، المجموعين هنا في محبّة الرسل الذين أعلنوا إيمانهم بالدمّ. وسوف يكون بقربكم أيضًا، أيها الإخوة رؤساء الأساقفة الأعزاء الذين، إذ تنالون درع التثبيت، تثبتون في العيش من أجل القطيع، متمثّلين بالراعي الصالح، الذي يساندكم إذ يحملكم على كتفيه. والربّ نفسه، الذي يتوق بشوقٍ لرؤية قطيعه مجموعًا، ليبارك ويحفظ البطريرك المسكوني، الأخ الحبيب برثلماوس، والوفد الذي أرسله إلى هنا كدليل على الشركة الرسوليّة.
***********
© جميع الحقوق محفوظة – حاضرة الفاتيكان 2017