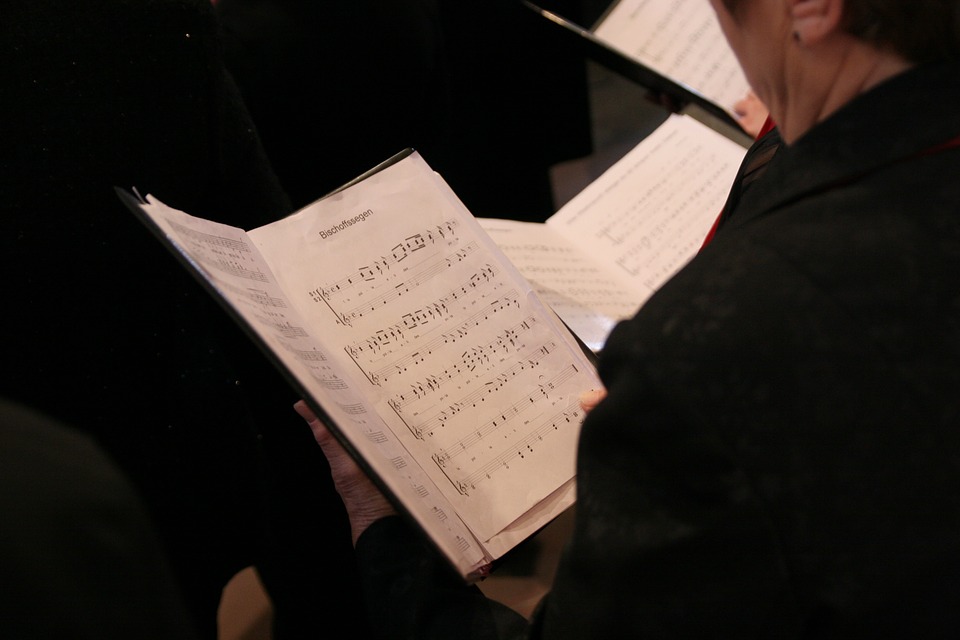نبدأ من حيثُ أنهينا القسم السادس من الموضوع، ألا وهي النقطة الثالثة. كنّا نتكلّم عن أن الموسيقى في العبادة المسيحية تعود إلى اللوغوس بأشكال ٍ ثلاثة:
3 – إنّ الكلمة المتجسّد (اللوغوس)، يقولُ البابا بنديكتوس، لا يُـــحدَّد بالمعنى الذي يُعطيه لتاريخنا الفرديّ، أو حتى للتاريخ بنوع عامّ . إنه معنى الحدث نفسه المنعكس في تنـــظيم الكون، الذي ينتشِلُنا من عزلتنا ليُدخلنا إلى شركة القدّيسين. هناك يضعنا الربّ في سعة في فضاء من الحريّة بأبعاد الخليقة كلّها. هذا البُعد الكونيّ لليتورجيّا المسيحيّة، يأتي التعبير عنه في المقدمة، حيث نشيد التقاديس يوحّدنا مع الكاروبيم والسرافيم ومجموعة الأجواق السماويّة. وهذا يشكّل أيضا المرجعيّة لصوت التسبحة للسرافيم الذي سَمِعَه اشعيا يرنّ في قدس الأقداس لهيكل أورشليم: “قدّوس، قدّوس، قدّوس هو الإله الذي مجده يملأ الأرض كلّها ” (اشعيا 6 : 3). إنّما في هذه الليتورجيّا الملائكــــيّة، نكون مدمَجين عند الإحتفال بالقداس الإلهيّ، وبأناشيدنا وصلواتنا، نتّحد بالليتورجيّا الكبيرة التي تضمّ الخلق كلّه.
لقد بيّـــن الآباءُ، القدّيس أوغسطينوس هو الذي، بصورة أخصّ، توخّى ربط البعد الكونيّ لليتورجيّا المسيحيّة برؤية العالم القديم الإغريقيّ – الرومانيّ. ففي أحد مؤلّفاته الآولى في الموسيقى، ما يزالُ متمسّكا تمامًا بنظريّة الموسيقى الفيـــثاغوريّة. ففي نظر فيثاغورس، الكونُ هو تركــــيبة رياضيّة (ماتيماتيك) كبيرة ( العلم العصريّ، ولا سيّما كيبلر وغاليلي ونيوتن، عاد جزئيّا إلى هذه الرؤية، وبالترجمة الماتيماتيكيّة للكون، جعلَ من الممكن استخدام قواه تقنيّا). فإنّ الفيثاغوريّين يشبّهون النظامَ الماتيماتيكيّ للكون (والكون هنا يعني: النظام) بمـــاهيّة (جوهر) الجمال. فإنّ ا الجمال ينشأ من نظام باطنيّ. ولكونــــه نظامًا، فهو يحملُ معنى. وهذا الجمالُ، كما يرى البابا بندكتس، لم يكن لهم من الطبيعة المرئيّة فحسب، بل الموسيقيّة أيضا.
في مسرحية (راوية) فاوست، يرجع ” غيث” مباشرة إلى المفهوم الفيثاغوريّ حينما يذكرُ ” نشيد الفضاءات الأخويّة“. والنظام الماتيماتيكيّ الذي يتحكم بالكواكب السيّارة ومسيرتها، يجعلُ كلّا منها يرنّ نغمة خفيّة تكون الطبيعة الأصليّة للموسيقى، والمسارات تمثّل النغمات (الأنغام)، والصفوف الرقميّة تمثّل (الوتيرة)، ومجموعة المدارات تمثّل (التناغم). فكان على الإنسان أن يستلهِم الموسيقى الباطنــــيّة للكون وتنظيمها، وان يجعل موسيقاه ترنّ بالنشيد الأخويّ للفضاءات السماويّة. وبما أنّ جمالَ الموسيقى ينتجُ من تناسبها مع الشرائع الوتيريّة والهرمونية للكون، فإنّ الموسيقى الإنسانيّة ستكونُ أجملَ بمقدار ما تشتركُ إشتراكـــًا حميمًا أكثر في الشرائع الموسيقيّة للكون.
يرى بنديكتس، إنّ نقلَ هذه النظرة إلى عالم الإيمان المسيحيّ، أدّى إلى سياق من الشخصنة بالتأكيد. إنّ ماتيماتيك الكون، كما فهمها الفيثاغوريون، لم تكن نظريّة محضة للأقدمين. عقل وحده كان في وسعه أن يكون في الاصل من الظواهر المُجهّزة بإحساس، مثل تلك التي كانوا يلاحظونها في الكون. إنّ حركات الكواكب العاقلة ماتيماتيكيّا لم تكن قابلة ً للشرح بصورة ٍ ميكانيكيّة محضة، بل كانت تقتضي، لكي تصبح مفهومة، أن تكون الكواكب مزوّدة بنفس و ” بعـــقل “. فكان من الطبيعيّ أن يمثّل المسيحيّون هذه الالوهات النجوميّة بالملائكة الذي هم أيضا ينيرونَ العالم. ومن ثمّة فإنّ إستيعابَ ” الموسيقى الكونيّة ” كان يعني سماعَ جوق الملائكة، وقد لقيَ هذا التقريبُ تشجيعًا برؤيا إشعيا.
إلى هذه الشخصنة الملائـــــكيّة للكواكب، أضيفت تلك التي ينسبها الإيمان الثالوثيّ إلى الآب واللوغوس وبنوما (الروح). ففهموا أنّ ماثيماتيك الكون لم تكن ظاهرة في حدّ ذاتها ولا من شأن الألوهات النجوميّة. أساسها كان العقلُ الخالق (للوغوس)، الذي فيه متضمّنة النماذج العليا لنظام العالم، التي بموجبها اللوغوس الخالق، بعمل الروح، يعطي العالمَ شكلــــــــــه. وبالنظر إلى مهمّته الخلاّقة، دُعي اللوغوس أيضا ” فــــنّ الله“. فاللوغس هو بالفعل الفنان الكبير، الذي فيه جميع الأعمال الفنيّة – وجمال الكون – محتواة منذ البدايات. فالإنشادُ بإتّفاق النغم مع الكون، يعني السيرَ في إثر اللوغوس والدنوّ منه. فكلّ فن إنسانيّ حقيقيّ، هو إذن مشاركة في فنّ الفنان بإمتيــــاز : المسيح! ، ورؤية الموسيقى هذه تعيدنا إلى العلاقات بين الفنّ واللوغوس.
يقولُ راتسنجر، إنّ هذا المكوّن الكونيّ والملائكيّ والفنّ الكبير للوغوس، يعطي الفن الليتورجيّ قياسه الحقيقيّ وعظمة منظوره أيضا: فإنّ إبداعا ذاتيّا محضـــًا لن يسعه أبدًا أن يبلغ إلى سعة الكون، ولا أن ينقلَ رسالة الجمال، فالإيمان إذن، لا ينقص من حريّة الفنان، بل بالعكس، يوسّع أفقه إلى اللامتناهي. يتبع