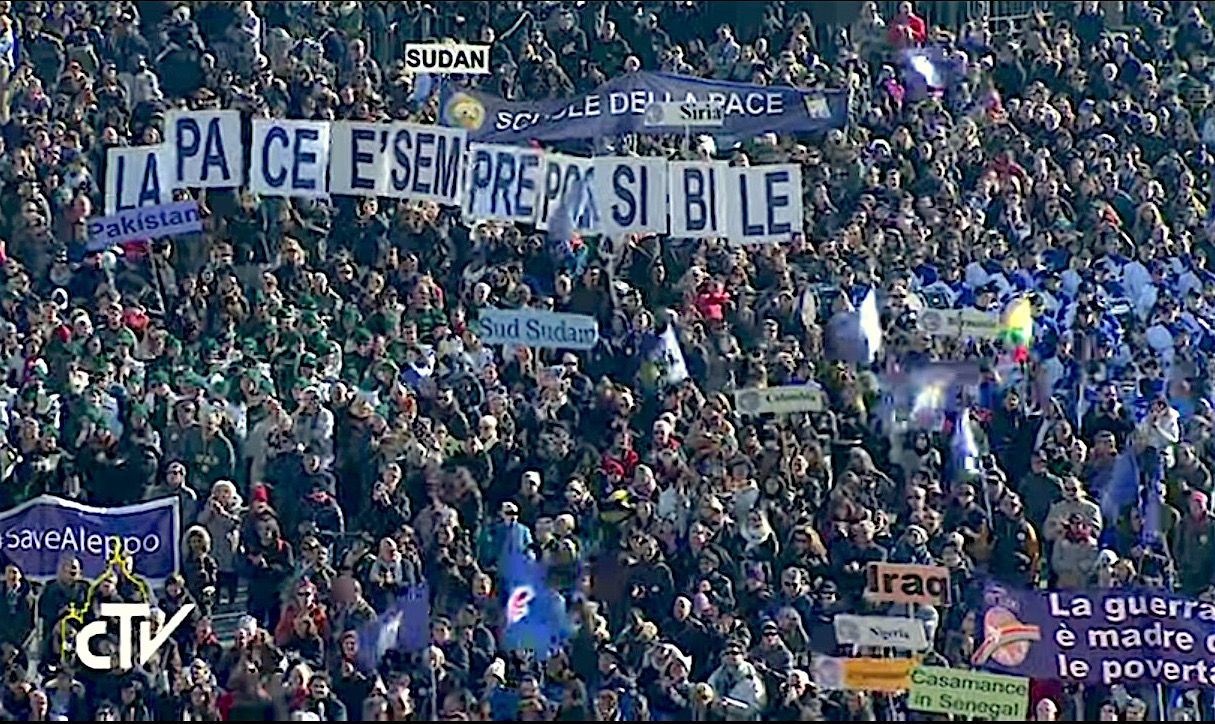ترأس البابا فرنسيس صباح اليوم الأحد في الأول من كانون الثاني يناير 2017 قداسا احتفاليا في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان لمناسبة اليوم العالمي للسلام وعيد العذراء مريم والدة الله. تخللت الاحتفال عظة للبابا قال فيها:
“وكانَت مَريمُ تَحفَظُ جَميعَ هذهِ الأُمور، وتَتَأَمَّلُها في قَلبِها” (لوقا 2، 19). بهذه العبارات وصف القديس لوقا البشير الموقف الذي تلقّت به مريم كل الأمور التي عاشتها في تلك الأيام. مريم، التي لم تكن ترغب في فهم هذا الوضع أو السيطرة عليه، عرفت كيف تحفظ في قلبها دخول الله إلى حياة شعبه. لقد تعلّمت من خلال أحشائها أن تصغي إلى خفقات قلب ابنها، وهذا الأمر علّمها أن تكتشف خفقات قلب الله في التاريخ، خلال حياتها كلِّها. لقد تعلّمت أن تكون أما، وبواسطة هذا التعلُّم وهبت ليسوع الخبرة الجميلة، خبرةَ أن يكون ابنًا. في مريم لم يصبح الكلمة الأزلي جسدا وحسب بل تعلّم أن يختبر الحنان “الأمومي” لله. مع مريم تعلّم الله ـ الطفل أن يصغي إلى تلهّف ومخاوف وأفراح وآمال شعب الوعد. معها اكتشف نفسه ابنا لشعب الله الأمين والقدوس.
في الأناجيل تبدو مريم كامرأة لا تُكثر في الكلام، ولا تتبوأ مناصب هامة، بل كانت لها نظرة يقظة عرفت كيف تحفظ حياة ورسالة ابنها وبالتالي وكل ما يحب ابنُها. عرفت كيف تحفظ طلائع الجماعات المسيحية الأولى وتعّلمت هكذا أن تكون أما لعدد كبير من الأشخاص. لقد اقتربت من الأوضاع المختلفة لتزرع بذور الرجاء. لقد رافقت الصلبان المحمولة بصمت في قلوب أبنائها. وتذكّرنا بهذه الحقيقة الكبيرة العديد من المزارات والكابلات المنتشرة في الأماكن الأكثر انعزالا والعديد من الصور المنتشرة في البيوت. لقد أعطتنا مريم الدفء الأمومي الذي يحيط بنا وسط الصعاب؛ الدفء الأمومي الذي يحول دون أن يطفئ أي شيء أو أي شخص ثورة الحنان التي أطلقها ابنها في قلب الكنيسة. حيث توجد أم يوجد الحنان. وتُظهر لنا مريم من خلال أمومتها أن التواضع والحنان ليسا فضيلتَي الضعفاء إنما الأقوياء، تعلمنا أننا لسنا بحاجة لأن نسيء معاملة الآخرين كي نشعر بأننا مهمّون (راجع الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، 288). ومنذ البدء كرّمها شعب الله الأمين والقدوس ورأى فيها أم الله القديسة.
إن الاحتفال بأمومة مريم، كأم لله وأمنا، في مطلع عام جديد يعني أن نتذكّر هذا اليقين الذي يرافق أيامنا: إننا شعب لديه أم، لسنا أيتاما.
تشكل الأمهات الترياق الأقوى لميولنا الفردانية والأنانية، ولانغلاقنا ولامبالاتنا. إن المجتمع الذي يفتقر إلى الأم، ليس مجتمعا باردا وحسب، إذ إنه مجتمع فقد القلب، وفقد “طَعْم” العائلة. إن المجتمع الذي يفتقر إلى هذا الأمر هو مجتمع بلا رأفة لم يترك مكانا إلا للحسابات الضيقة والأوهام. إن الأمهات، وحتى في الأوقات الأصعب، يعرفن كيف يشهدن للحنان والتفاني غير المشروط وقوة الرجاء. لقد تعلمتُ الكثير من أمهات لأبناء في السجن أو ممددين على أسرة المستشفيات أو ضحايا عبودية المخدرات، لم يستسلمن وقررن متابعة نضالهن على الرغم من البرد والحر والمطر والجفاف. أو من الأمهات في مخيمات اللاجئين أو في خضم الحروب القادرات على معانقة آلام أبنائهن دون أن تزل لهن رجْل. أمهات يهبن حياتهن بكل ما للكلمة من معنى كي لا يضيع أحد من أبنائهن. حيث توجد الأم توجد الوحدة، ويوجد الانتماء، انتماء البنين.
إن تذكار طيبة الله في وجه مريم الأمومي، في وجه الكنيسة الأمومي، في أوجه أمهاتنا، مع بداية العام الجديد يحمينا من مرض “التيتم الروحي”، هذا التيتم الذي تعيشه النفسُ عندما تشعر أنها تفتقر إلى الأم وإلى حنان الله. هذا التيتم الذي نعيشه عندما ينطفئ فينا شعور الانتماء إلى عائلة، إلى شعب، إلى أرض، وإلى إلهنا. هذا التيتم الذي يجد فسحة له في القلب النَّرجِسِي الذي يعرف أن ينظر لنفسه ولمصالحه فقط وينمو عندما ننسى أن الحياة هي هبة نلناها من الآخرين، ونحن مدعوون لتقاسمها داخل هذا البيت المشترك.
إن هذا التيتم الذي يعتبر ذاته مرجعا هو الذي حمل قايين إلى القول “أحارس لأخي أنا؟” (تكوين 4، 9)، كمن يقول: إنه لا ينتمي إلي، لا اعترفُ به. إن موقف التيتم الروحي هذا لهو بمثابة سرطان يُتلف ويحط من قدر النفس بصمت. هكذا نتهاون شيئا فشيئا عندما لا ينتمي إلينا أحد ولا ننتمي إلى أحد: أحط من قدر الأرض لأنها لا تنتمي إلي، أحط من قدر الآخرين لأنهم لا ينتمون إلي، أحط من قدر الله لأني لا أنتمي إليه… وفي نهاية المطاف نحط من قدر أنفسنا لأننا ننسى من نحن، وننسى “الاسم” الإلهي الذي نحمله. إن فقدان الروابط التي تجمعنا، وهو مثال نموذجي على ثقافتنا المفتتة والمنقسمة، يؤدي إلى نمو هذا الشعور بالتيتم وبالتالي بالفراغ الكبير والوحدة. إن غياب التواصل الملموس (لا الفرضي) يحرق قلوبنا (راجع الرسالة العامة كن مسبحا، 49) ويُفقدها القدرة على الحنان والذهول والشفقة والرأفة. إن التيتم الروحي يُفقدنا ذاكرة ما يعني أن نكون أبناء وأحفادا ووالدين وأجدادا وأصدقاء ومؤمنين. يفقدنا ذاكرة قيمة اللعب والغناء والضحك والراحة والمجانية.
إن الاحتفال بعيد أم الله القديسة يعيد إلى وجهنا بسمة الشعور بأننا شعب وأننا ننتمي إلى بعضنا البعض؛ ومعرفة أنه داخل الجماعة فقط، وداخل العائلة، يجد الأشخاص الجو، أو الدفء الذي يسمح لهم بأن يتعلموا كيف ينمون إنسانيا، لا كمجرد أغراض مدعوة لأن تَستهلك وتُستهلك. إن الاحتفال بعيد أم الله القديسة يذكّرنا بأننا لسنا سلعة للتبادل أو أجهزة لتلقي المعلومات. إننا أبناء، إننا عائلة، إننا شعب الله.
إن الاحتفال بعيد أم الله القديسة يدفعنا لخلق فسحات مشتركة والاعتناء بها، كي تعطينا معنى الانتماء والتجذّر، تُشعرنا أننا في بيتنا داخل مدننا، ضمن جماعات توحّدنا وتعضدنا (المرجع نفسه، 151).
إن يسوع المسيح، وعندما أعطانا حياته كأعظم هبة على الصليب، لم يشأ أن يحتفظ بشيء لنفسه وإذ وهبنا حياته وهبنا أيضا أمه. فقال لمريم: ها هو ابنك، ها هم أبناؤكِ. ونحن نريد أن نستقبلها في بيوتنا، في عائلاتنا، في جماعاتنا وفي بلداننا. نريد أن نلتقي بنظرتها الأمومية. هذه النظرة التي تحررنا من التيتم؛ هذه النظرة التي تذكّرنا بأننا أخوة: أنني أنتمي إليك وأنت تنتمي إلي، بأننا جسد واحد. هذه النظرة التي تعلمنا ضرورة الاعتناء بالحياة بالطريقة نفسها وبالحنان نفسه كما فعلت هي: زارعين الرجاء، زارعين الانتماء، وزارعين الأخوة.
إن الاحتفال بعيد والدة الله القديسة يذكّرنا بأن لدينا الأم؛ لسنا أيتاما، لدينا أم. لنعلن معا هذه الحقيقة! وأدعوكم لأن تفعلوا هذا ثلاث مرات كما فعل المؤمنون في أفسس: يا أم الله القديسة! يا أم الله القديسة! يا أم الله القديسة!
(إذاعة الفاتيكان)