DERNIÈRES NOUVELLES
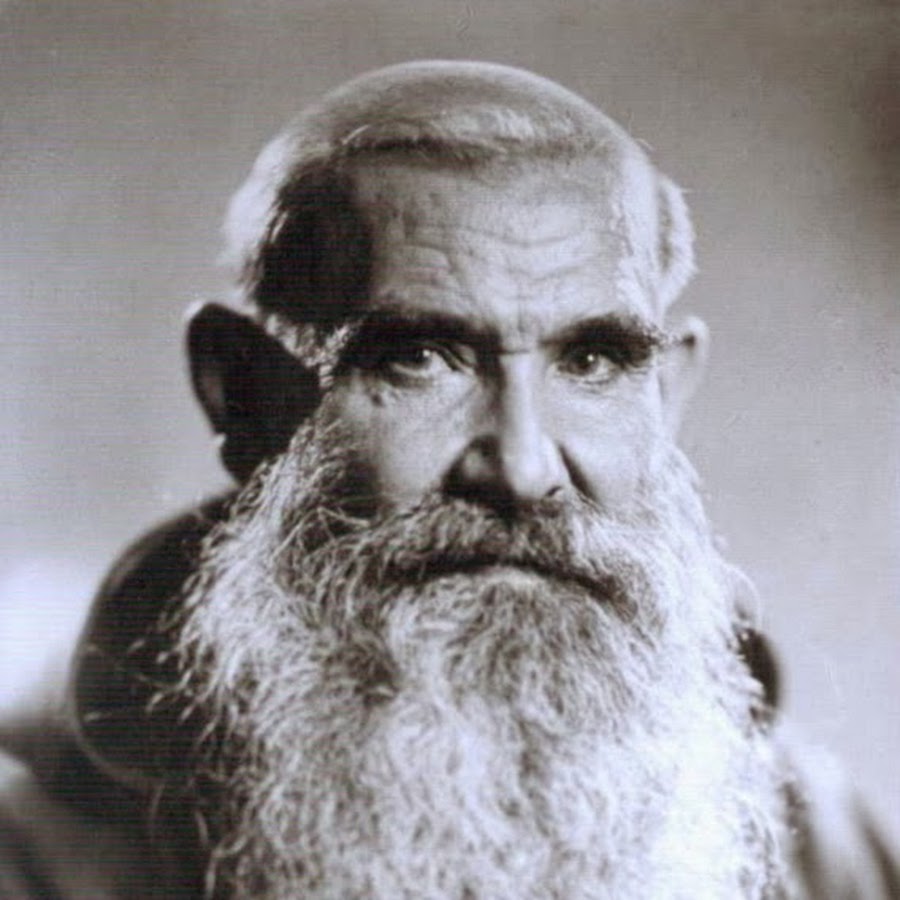
Nov 21, 2017 20:13
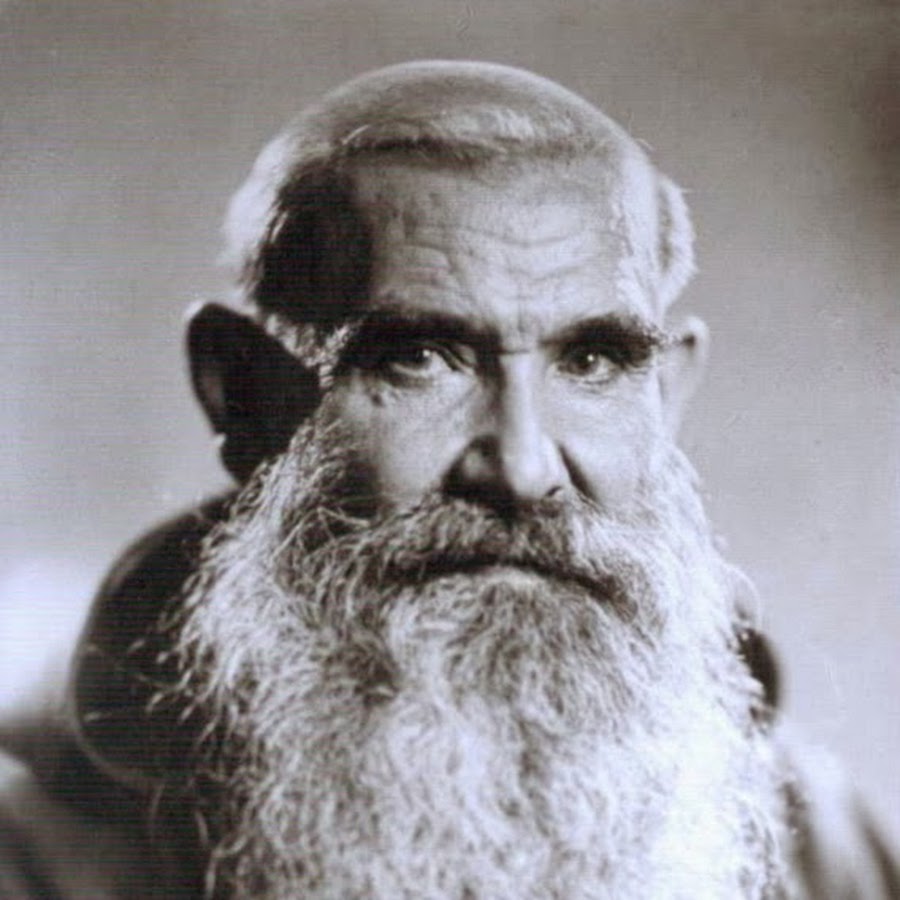
Abouna Yaacoub - Wikimedia