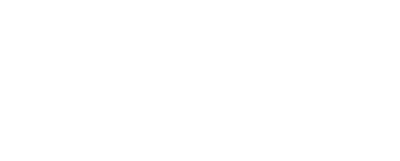- لدى كلّ الحضارات الكبيرة التي عرفناها وما زلنا ، عاملٌ مشترك هو الدين . يبدو كأنّ التعاليم كلّها تعزفُ ألحانــًا متشابهة ، كالدعوة إلى الإعتدال ، والتنبيه من الأنانيّة والإستقلاليّة . لماذا ، إذا ، لا تكون الديانات كلّها واحدة ؟ ولماذا تصنيفُ الإله المسيحيّ على أنه أفضل من الإله الهنديّ ؟ ولماذا نحصُر الخلاص بديانة ٍ واحدة ؟
جواب البابا : إن هذا الإقتراح ظهر خلال عصر التنوير مع ظهور البحث التاريخيّ في الدين ، وكان قد ظهر قبل ذلك ، لكن يمكن تنفيذه عندما نتمعّن بتفحّص الديانات . هناك أبعاد ومستويات مختلفة ، كما أنّ هناك ديانات مريضة بشكل واضح ، قد تكون بعض الأحيان هدّامة للإنسان .
إنّ النقد الماركسيّ للدين صحيحٌ بقدر ما هناك من ديانات أو ممارسات دينيّة تغرّب الإنسان . لنأخذ مثلا أفريقيا ، حيث يكوّن الإيمان بالأرواح حتى الآن عائقا كبيرًا يحولُ دون بناء الأطر الإقتصاديّة الحديثة لتنمية البلاد . فحيث عليّ حمايةُ نفسي دائمًا وفي كلّ مكان من الأرواح ، وحيث خوف غير منطقيّ يطبع مشاعرَ الحياة كلّها نكون بالتأكيد بعيدين عمّا يطمح إليه الدين بصلبه . بإمكاننا أن نرى في عالم الديانات الهنديّة ( الهندوسيّة ) " هي في الواقع تسمية مضلّلة تشمل العديد من الديانات " أشكالا مختلفة للغاية : بعضها سام ٍ وطاهر يتّسم بفكرة الحبّ ، لكنّ البعض الآخر وحشيٌّ جدّا وينطوي على طقوس قتل.
نعرف أنّ الأضاحي البشريّة طبعت تاريخ الديانات بطريقة فظيعة ، كما نعرف أنّ الديانات السياسيّة تحوّلت إلى وسائل للقمع والتخريبْ . كذلك عرفنا ظواهر مرضيّة في الدين المسيحيّ نفسه ، فإحراقُ الساحرات هو عودة إلى الجرمانيّة . وقد فرض إعلان البشارة بصعوبة التخلّي عنه مع بداية العصر الوسيط ، فعاد ليظهر في نهاية القرون الوسطى مع تراجع الإيمان . بكلمة واحدة ، إنّ الآلهة جميعها ليست متساوية ، وهناكَ آلهة سيّئة جدّا ، نجدُ ذلك في عالم الآلهة اليونانيّة أو الهنديّة . إنّ فكرة تساوي الديانات تنتهي بالفشل ببساطة بمجرّد النظر إلى واقع تاريخ الديانات .